
مُجتمعات “ما بعد كورونا” كمُجتمعاتٍ غاضِبة
كيف يُمكن أن أكتب سرديّةً تَصِفُ مُجتمعات ما بعد كورونا؟ إنّ هذا السؤال، كما هو جليّ، يطلب تفسيراً وتفكيكاً للوضْع البشريّ الذي يعيشه الإنسانُ المُعاصِر بوصفه كائناً “انتقاليّاً” أي كائناً يتميّز بفعل المرور “من.. إلى”، من الوضع الطبيعيّ إلى وضعٍ مُختلفٍ ومُغاير، من الأنظمة الدكتاتوريّة التسلّطيّة إلى الأنظمة الديمقراطيّة، من وضعيّة السِّلم إلى وضعيّة الثورة ومن حالة الصحّة إلى حالة الأوبئة والفيروسات.
السؤال المطروح هنا، هو كيف يُمكن أن أصوغ سرديّةً عن نفسي بوصفي كائناً انتقاليّاً، بوصفي كائناً مُتغيّراً لا يَحمل هويّةً ثابتة وتحكمه مجموعةٌ من الأوضاع المُتبدِّلة؟ هل يُمكن القول، مثلاً، إنّي كائنٌ ناجٍ من حرب الأوبئة؟ أو هل يُمكن وصفي بأنّي كائنٌ مُترقِّب للمرض والعِلاج في الوقت نفسه؟ هل أنا مثلاً حاملٌ لفيروسٍ وأنا قادِر على التعافي منه أو أنّي مريضٌ في انتظار الموت؟
هذه الأسئلة كلّها لم تكُن تؤرِق تفكير الإنسان التقليديّ، إلّا منذ دخوله مُنعرَجاً جديداً يُسمّيه المفكّر التونسي فتحي المسكيني “عصر الأوبئة”. فقد دخلت الإنسانيّة مُنقلباً جديداً منذ سنة 1892 بعد ظهور مفهوم الفيروسات. وهي مرحلة يصفها المسكيني بمرحلة “الانقلاب في السياسات الوبائيّة الكبرى للحداثة”؛ إذ جرى الانتقال من عصر الأمراض التقليديّة إلى عصرِ الأمراض اللّامرئيّة، حيث فَرضت هذه الأوبئة نِظاماً جديداً على العالَم يُمكن ترجمته من خلال مُصطلحاتٍ من قبيل “العزْل”، “الحجْر الصحّي الإجباري”، “الإغلاق”، “حذْر التجوُّل”، “تطويق البؤر”، “فتْح/ إغلاق الحدود”… وهي كلّها مُصطلحات قد تحيلنا إلى مفهوم “الوحدة” بمعنى العُزلة، وهذا ما يجعلنا نَستحضر موقفَيْن الأوّل لجان بول سارتر عندما أَعلنَ أنّ “الجحيم هم الآخرون”، باعتبار أنّ الآخر أَصبح تهديداً لكينونتي بوصفه حاملاً للفيروس، ما يُدخل الإنسان المُعاصِر في وضعيّة “الخوف” و”الترقُّب”: الخوف من الغَير الذي أَصبح تهديداً لكياني، وترقُّب الإصابة بالمرض.
أمّا الموقف الثاني، فهو لفيكتور هيغو في مقولته “الجحيم كلّه يكمن في كلمة العزلة”، حيث يَفرض الوباء نَوعاً من الحجْر الإجباري. وعلى حدّ تعبير فتحي المسكيني، فإنّ مدينة “وهان” الصينيّة التي يزيد عمرها عن 3500 سنة، والتي هي من أكثر المُدن استقبالاً للطلبة، تحوَّلت إلى “جحيم ميتافيزيقي” وباتت شبه مُقفِرة.
ثنائيّة الخروج والبقاء
هذه الثنائيّةُ بين الخروجِ إلى العالَم و”البقاء في البيت”، بوصفه المُستَقرَّ ومَكان إقامتنا الدائم، أَدخلت الإنسانَ المُعاصِرَ في نَوعٍ من السرديّة التي تحكمها ثنائيّة “القلق” و”الغضب”، ولاسيّما أنّه كائن “يعاني” أو يرزَح تحت وطأة الضغط. ولمّا كان الضغط يولِّد الانفجار، بحسب قوانين الفيزياء، فإنّ تطبيق القانون الفيزيائي على المُجتمع يكشف لنا أنّ كلّ الثورات، ومنها مثلاً “ثورات الربيع العربي”، كانت نتيجة الضغط، وأنّ جائحة كورونا تَفرض نَوعاً من الضغط على الإنسان المُعاصِر: أوّلاً الضغط النفسي، حيث دَخلت مُجتمعاتٌ في حالةٍ من الاكتئاب الحادّ نتيجة خضوع الإنسان لأزمةٍ نفسيّة عميقة ناشئة عن الوضْع غير “الطبيعي أو غير العادي” الذي يحياه، ثانياً الضغْط المُتعلّق بالسوق، حيث أَدخل تراجُع التجارة والمُبادلات التجاريّة العالَم كلّه في ضيقٍ اقتصادي.
ما الذي نعنيه بالغضب؟
بناءً على ما تقدَّم، ترانا نسأل: ما الذي نعنيه بالغضب؟ وهل ثمّة آثار تاريخيّة لتحوُّل الإنسان إلى كائن غاضب؟ الغضب، بوصفه ردّ الفعل العنيف على فعلٍ ما، هو شعور مواكِب للإنسان. وتصوِّر لنا السرديّة التاريخيّة للإغريق، من خلال أشعار هيرودوت وهوميروس، مقدار الغضب الذي ارتبط بمجموعة من الآلهة المُجسِّدة للشرّ، مثل “موروس” إله الموت القاسي والدّمار، و”زيوس” كبير الآلهة والبشر، إله البرق والرعد والسماء وحاكِم قوى الطبيعة التي تُثير الخشية والخوف في المُواطن الإغريقي.
وتذكِّر أسطورة خلْق البشر بغضب “زيوس” الشديد من برومثيوس بسبب هيامه بحبّ البشر إلى الحدّ الذي دَفعه إلى سرقة النار من جبل الأولمب من أجلهم، الأمر الذي أدّى إلى سخط “زيوس” وغضبه على البشر وأمره بشواء لَحمهم.
أمّا مُحاورة أفلاطون الفيدروس، التي تَدرس مسألة النَّفس البشريّة، فتُحيل على الصراع القائم بين النَّفس الغاضبة وتلك العاقلة، والمتمثِّلة بعربة ذات جوادَين أحدهما أبيض وثانيهما أسود، يحاول كلٌّ منهما الذهاب في الاتّجاه المُغايِر للآخر كتعبيرٍ رمزيّ عن صراع العاطفة مع العقل. فكلّما رزحَ الإنسانُ تحت وطأة المُعاناة، ازداد غَضباً ونقمة، لأنّ الغضب هو ردّة فعل عميقة تجاه مُحاولات استلاب إرادة الإنسان وحريّته. ألَم يغضب النبي موسى من شعبه في حادثة العجل الذهبي؟ “كَانَ عِنْدَمَا اقتَرَبَ إِلَى المحلَّةِ أَنَّهُ أَبْصَرَ الْعِجلَ وَالرَّقْصَ، فَحَمِيَ غَضَبُ مُوسَى وَطَرَحَ اللَّوحَينِ مِنْ يَدَيْهِ وَكَسَّرَهُمَا فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ (سفر الخروج 32 : 19)”. ثمّ، أوَ لم تبدأ قصّة الخلْق من خطيئةٍ، ومن غضب الإله من “آدم” وطرده من جنّته؟
هذا كلّه يجعلنا نتساءل عن منشأ الغضب وطبيعته لدى الإنسان، فهل هو قائمٌ بالفطرة كما قال فرويد في كِتابه “قلق في الحضارة”، حيث رأى أنّ الإنسانَ ليس ذاك الكائن الطيِّب السَّمح الذي يُقال إنّه يُدافع عن نفسه حينما يُهاجَم فحسب، وإنّما هو على خلاف ذلك، كائن تندرج العدوانيّة لديه بالضرورة وبقدرٍ لا يُستهان به، ضمن مُعطياته الغريزيّة؟ وهل الإنسان كائن خيِّر، لكنّ المُجتمع هو الذي أفسده مثلما ذهب إلى ذلك جان جاك روسّو؟
لعلّ الأمر الخطير يكمن في هذه الطاقة الغريزيّة المكبوتة التي نُحاول قمْعها في كلّ مرّة، بغية تحمُّل الأعباء والأثقال الكثيرة التي تواجهنا. وهو ما أثبتَتْهُ تجربة الحربَين العالَميّتَين وما يُثبته في وقتنا الرّاهن التدهورُ الذي أفضت إليه الثورات العربيّة وآثاره السلبيّة على الفرد العربي. فالعالَم على قاب قوسَين أو أدنى من “الانهيار”، حيث يشعر الفرد باستمرار بأنّه مُهدَّد وأنّه في خَطَر، بعدما بات الأمر غير متعلِّق بالحروب التقليديّة، بل بما يُمكن تسميته بـ”حروب التلقيح”، وحيث بات الذي يمتلك اللّقاح اليوم يمتلك سلطةَ إدارة العالَم. وكأنّنا بذلك نُخرِج مقولة “الشرّ” من سياقها الميتافيزيقي لوضْعها في سياقها الميكروسكوبي، بما أنّ الشرّ الذي يُرعب البشريّة اليوم، هو ذلك الكائن المُتناهي في الصغر الذي لا يُمكن أن تُدركه العَين المجرَّدة.
أيّ إنسان تصنعه الكورونا؟
يَصِفُ الفيلسوفُ الفرنسيّ المُعاصر ميشال أونفراي المُنتمي إلى فلاسفة “ما بعد الحداثة” الوضعَ المُترتِّب عن جائحة كورونا بعبارات من قبيل: “الانهيار”، “الانحدار”، “الانحطاط”، مُعتبراً أنّ الحضارة الغربيّة الآن، هي في حالة “هَرَمٍ”، وأنّ ذلك هو من مَظاهر أفول الغرب. فهذا الوضع الذي يُنذر بالنهاية، لا ينطبق على الإنسان في العالَم الغربي فحسب، بل على الإنسان بصفة عامّة، وذلك عائد بحسب أونفراي إلى طريقة تعامُل “السلطة القائمة” وأجهزة الدولة مع الجائحة. من ذلك مثلاً عجْز هذه السلطات عن توفير الأقنعة أو المُعقّمات وإيجاد التلقيح و”ترْك المرضى يلفظون أنفاسهم الأخيرة أمام المُستشفيات”، وما يشير إليه كلّ ذلك من إعلانٍ عن موت الإنسانيّة.
وكلام أونفراي عن حضارةٍ تحتضر وتلفظ أنفاسها الأخيرة يُحيل إلى مَوقف الفيلسوف الألماني شوبنهاور، أب الفلسفة التشاؤميّة، حينما قال ذات مرّة إنّنا كالحُملان التي تلهو في حقلٍ تحت أنظار الجزّار الذي ينتقي منها واحداً يليه آخر كفريسةٍ له. فنحن البشر، شأن هذه الحُملان، غير واعين بهَول المصير الذي ينتظرنا أمام حاضرٍ يتحكَّمُ فيه المرض والفقر والتشوُّه وفقدان البصر أو البصيرة. أَصبح الإنسانُ كائناً في انتظار “الموت”، كائناً يفكِّر في الآخرة بدل التفكير في المُستقبل، كائناً يترقّب خائفاً وعدوانيّاً. غدا كائناً يستبدل بُعدَه الوجودي بالبُعد الاقتصادي. فها هُم تجّار الحروب يحتكرون بَيع الأدوية والأقنعة واللّقاحات مع تغليب جانب المنفعة على الجانب الإنساني، كإعلانٍ عن موت إنسانيّة الإنسان.
ثمّة مَن يذهب إلى القول إنّ مَهمّة الفلسفة تتمثّل في تأويل الأحداث والوقائع، وثمّة مَن اعتبرَ أنّ وظيفتها تتمثَّل هي إعادة إحياء الأمل وإخراج الإنسان من حالة يأسه وبؤسه بعكس شوبنهاور الذي اعتبر الأملَ نوعاً من الوهْم: “الأمل هو اختلاط الرغبة في الحصول على شيء ما مقابل احتماليّة حدوثه”. أَلَم يَقُل ألبير كامو أيضاً عن الأمل إنّه “فعل التضليل النموذجي”؟
في مطلق الأحوال نقول إنّ وظيفة الفلسفة اليوم تكمن في فضْح رداءة الواقع لكونها ضَرباً من التحقيق في الطبيعة الإنسانيّة، وذلك حتّى لا ينسى الإنسان أنّه إنسان أوّلاً وآخراً. فهي بهذا المعنى ضربٌ من إعادة البحث عن المعنى الأصلي لهذا الإنسان الأخير المُحتضِر، والذي يَرزح تحت وطأة الألم.
* بشير الذكواني
باحث في الأنساق الفلسفيّة من تونس

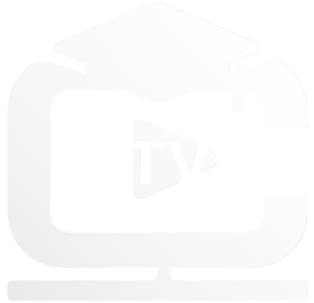


![[ID: SplxcD3ApP4] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/08/id-splxcd3app4-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: oycZWQBv-so] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/08/id-oyczwqbv-so-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: ZMiWOmdBoC8] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/08/id-zmiwomdboc8-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: XdwA2AFdX4c] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/08/id-xdwa2afdx4c-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: 8tFeJAGDu2Y] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-8tfejagdu2y-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: LNEIgo0dP7s] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-lneigo0dp7s-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: oCDJSQvT7UI] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-ocdjsqvt7ui-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: 66v7AQiN5G8] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-66v7aqin5g8-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: yRfOZxRpJZs] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-yrfozxrpjzs-youtube-automatic-1-360x203.jpg)
![[ID: g6oUbZI_IEI] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-g6oubziiei-youtube-automatic-1-360x203.jpg)
![[ID: 1luuXmXQ4KI] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-1luuxmxq4ki-youtube-automatic-1-360x203.jpg)
![[ID: shKLCi75YWw] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-shklci75yww-youtube-automatic-1-360x203.jpg)




![خاص: [ID: AUPOVTP40ys] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-aupovtp40ys-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: qaqoeuN_dsE] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/07/id-qaqoeundse-youtube-automatic-360x203.jpg)
![خاص: [ID: w7FjF_h-4Xc] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/07/id-w7fjfh-4xc-youtube-automatic-360x203.jpg)
![خاص: [ID: wp2KO3gEIc0] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/07/id-wp2ko3geic0-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: Cj6Jp8m5fCI] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-cj6jp8m5fci-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: Y5pAAVaMrfU] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-y5paavamrfu-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: VLCxPmFagU8] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-vlcxpmfagu8-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: gAUdDgYJrbU] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-gauddgyjrbu-youtube-automati-360x203.jpg)
![[ID: QQGE9bmQ5fY] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/02/id-qqge9bmq5fy-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: mqP6TotIRLo] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/02/id-mqp6totirlo-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: eoft3aRkhYE] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/02/id-eoft3arkhye-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: jkXBixeZjZE] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/02/id-jkxbixezjze-youtube-automatic-360x203.jpg)

![[ID: o8Pa6uK5bbw] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/02/id-o8pa6uk5bbw-youtube-automatic-360x203.jpg)


![[ID: 3jcBsN8wVGo] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-3jcbsn8wvgo-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: M8IM9s5Ddiw] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-m8im9s5ddiw-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: qbol2X6ahug] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-qbol2x6ahug-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: VlqMjXoPCJE] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-vlqmjxopcje-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: TL2nAJwpIRs] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/04/id-tl2najwpirs-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: eK5_eDDwvLc] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/04/id-ek5eddwvlc-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: IMfmbP5VkJs] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/04/id-imfmbp5vkjs-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: c1lM8tb4_NU] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/03/id-c1lm8tb4nu-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: CQh8QDII3LA] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-cqh8qdii3la-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: CHB4wqkQoD8] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-chb4wqkqod8-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: x3uQAE4xcW4] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-x3uqae4xcw4-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: XeMnPURyPeY] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-xemnpurypey-youtube-automatic-360x203.jpg)
![خاص: [ID: coUuGUYPcS4] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/05/id-couuguypcs4-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: 5XHTMVS7C7Q] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2021/05/id-5xhtmvs7c7q-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: bJWTnGoF4vA] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2021/05/id-bjwtngof4va-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: o40VpK6Emdc] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2021/03/id-o40vpk6emdc-youtube-automati-360x203.jpg)
![[ID: 7bNS4oWtOSk] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2020/10/id-7bns4owtosk-youtube-automatic-360x203.jpg)

![[ID: l2IeQ7HvrUU] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2020/10/id-l2ieq7hvruu-youtube-automatic-360x203.jpg)


