
الانتخابات المغربية ، الدولة العميقة تعيد هيكلة المشهد السياسي
تقديـــم
ليفهم القارئ العربي حقيقة ما جرى في الانتخابات الأخيرة المنظمة في المغرب، والنتائج “الغريبة” التي أفرزتها، لابد من التذكير ولو بإيجاز بالمقدمات والعوامل التاريخية والبنيوية المهيكلة للمشهد السياسي المغربي عبر العقود الستة الماضية، اي بالضبط من 1961، سنة صعود الحسن الثاني على العرش خلفا لوالده محمد الخامس، إلى السنة الحالية 2021، سنة الإغلاق النهائي لقوس الانفتاح النسبي الذي فتح مع حكومة التناوب التوافقي في نهاية التسعينات من القرن الماضي، وتعزز بدستور جديد بعد حراك 20 فبراير/شباط 2011 في سياق ما سمي بالربيع العربي* .
من قطبية اليسار/المخزن القصر ومحيطه إلى تعددية إيديولوجية وسياسية.
برز “الاستثناء المغربي” بكون المغرب البلد العربي والافريقي الوحيد الذي لم تصل فيه حركة التحرر الوطني للسلطة بعد الحصول على الاستقلال رغم إخراجها للاستعمارين الفرنسي والاسباني، وذلك بسبب نجاح الأول في جر القيادة البورجوازية للحركة لتوقيع اتفاقية، “ايكس ليبان” المشؤومة التي قبلت بموجبها الحركة الوطنية المغربية عودة الملك محمد الخامس لعرشه (نفي لمدغشقر بين 1953و 1955)، وإشرافه على تكوين أول حكومة وطنية سنة 1956مكلفة بالتفاوض مع فرنسا على ترتيبات الاستقلال الشكلي.
وقد حلل الشهيد المهدي بن بركة في كتابه الاختيار الثوري (1962) ظروف وملابسات سقوط حركة التحرر الوطني المغربية في أخطاء قاتلة بسبب ضعف تكوينها وقلة خبرتها في أخطاء قاتلة أدت بها لفقدانها لزمام المبادرة السياسية بعد حل تنظيمات المقاومة وجيش التحرير، ومركزة كل السلطات في يد القصر، وشكلت إقالة الحكومة الوطنية للأستاذ عبد الله ابراهيم أحد القادة التقدميين في شهر ماي 1960، القطيعة النهائية بين النظام والحركة التقدمية.
منذ ذلك التاريخ استمر الصراع بين الحركة التقدمية ممثلة بحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بزعامة الشهيد المهدي بن بركة، والحزب الشيوعي المغربي الذي تعرض للحل بقرار من المحكمة سنة 1959 من جهة، والقصر محاطا ومدعوما بكل فلول الاستعمار الجديد والاقطاع القبلي والبورجوازية الكمبرادورية من جهة أخرى. تمثلت المحطة الأولى لهذا الصراع حول وضع أول دستور للبلاد قاطع الاستفتاء عليه الاتحاد الوطني سنة 1962، لأنه اعتبره دستورا ممنوحا يشرعن الحكم المطلق، وداخل أول برلمان منتخب سنة 1963 قادت الحركة الوطنية بجناحيها، معارضة قوية وتمكنت من إسقاط الحكومة بتقديم ملتمس رقابة سنة 1965. وكانت الانتفاضة الشعبية في 23 مارس من نفس السنة والتي قمعت بقسوة شديدة استشهد على إثرها العشرات من المواطنين والمواطنات، المبرر الذي استند اليه النظام لإعلان حالة الاستثناء، وتجميد الحياة السياسية، ومصادرة الحريات العامة، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كان أبرزها اختطاف واغتيال زعيم المعارضة اليسارية الشهيد المهدي بن بركة في 29 أكتوبر 1965.
بعد تلك الجريمة البشعة، اضطر قادة الحركة التقدمية إما اللجوء للخارج أو العمل السري وتجميد كل الأنشطة العلنية باستثناء الأنشطة النقابية والجمعوية. في هذا السياق ومباشرة بعد نكسة 1967، وتحت تأثير انتفاضات الطلاب والعمال بأوروبا سنة 1968، والثورة الثقافية في الصين، تم تأسيس تنظيمات ثورية سرية أبرزها تنظيم مسلح داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بقيادة المرحوم الفقيه البصري، وهو الذي انكشف سنة 1969 (محاكمة مراكش الكبرى ) وقاد انتفاضة مسلحة في مارس 1973 منيت بالفشل، واستشهد على إثرها عشرات الثوار، وتنظيمات ماركسية لينينية تعرضت بدورها لحملة قمعية شرسة توجت بمحاكمة 1977.
خلال الفترة المشحونة التي سميت فيما بعد بسنوات الجمر والرصاص، تعرض النظام لمحاولتي انقلاب سنتي 1971 و1972 نجا منهما بأعجوبة، ولكنهما تسببتا في عزلته داخليا وخارجيا مما دفعه للبحث عن مخرج من الأزمة بكل الوسائل، ومنها الاتصال بقادة الأحزاب الوطنية ودعوتهم للمشاركة في الحكومة.
في هذا السياق مثلت قضية تحرير واسترجاع الصحراء من الاستعمار الإسباني، فرصة تاريخية سواء للدولة أو للأحزاب الوطنية للخروج من نفق حالة الاستثناء، وتدشين مرحلة جديدة تحت شعار “الإجماع الوطني والسلم الاجتماعي” الذي روجه الإعلام الرسمي بقوة.
1 – المسار الانتخابي والصراع الاجتماعي
في منتصف سبعينات القرن الماضي، عقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد التخلي عن اسم الاتحاد الوطني، مؤتمره الاستثنائي الذي شكل قطيعة مع تجاربه السابقة، حيث تبنى لأول مرة رسميا الاشتراكية العلمية كمرجعية ومنهج، والنضال الديموقراطي كخط سياسي مؤطر باستراتيجية التحرير والديموقراطية والاشتراكية، وذلك تتويجا لتقييم خمسة عشر سنة من المواجهات، والمحاولات الفاشلة لتغيير جذري للنظام السياسي. لكن تفعيل الاستراتيجية الجديدة سيصطدم بثلاثة عوائق كبرى، العائق الأول تمثل في اغتيال الشهيد عمر بنجلون، منظر الحزب وزعيم التيار الثوري ومبدع الاستراتيجية المذكورة، على يد عصابة مسخرة للشبيبة الإسلامية التي كانت مجرد أداة تحركها المخابرات. والعائق الثاني تجلى في تداعيات حرب استرجاع الصحراء مع البوليزاريو التي حظيت بدعم قوي من الجزائر وليبيا القذافي وكوبا وبعض دول أوروبا الشرقية. والعامل الثالث والأكثر تأثيرا، تنكر النظام لوعوده بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإقدامه على تزوير سافر للانتخابات الجماعية والبرلمانية سنة 1977، حيث قلص عدد الفائزين الاتحاديين في الانتخابات البرلمانية من حوالي تسعين فائز الى خمسة عشر فقط، بحجة رفض قيادة الاتحاد عرض المحاصصة التي اقترحها وزير الداخلية قبيل إجراء الانتخابات !
وهكذا، كانت تلك الانتخابات التي جرت تحت شعار ” المغرب الجديد ” أكبر مناورة سياسية وظفها النظام لتعبئة أعيان الاقطاع القبلي ورموز البورجوازية الطفيلية ودفعهم للترشح كمستقلين للبرلمان بتوجيه وتأطير من وزارة الداخلية التي بادرت بعد إنجاحهم بالتزوير، الى تجميعهم في إطار حزب جديد بقيادة صهر الملك آنذاك، وسمي هذا الكائن السياسي/ الاداري بالتجمع الوطني للأحرار، وكلف رئيسه المعين بتشكيل حكومة ائتلافية مع حزبي الحركة الشعبية والاستقلال. ومن غريب الصدف أن يمنح لهذا الحزب من جديد الأغلبية النسبية في الانتخابات الأخيرة ويعين “زعيمه (مديره العام في الحقيقة ) رئيسا للحكومة القادمة، رغم أنه – وهذه مفارقة لم تقع في أي بلد في العالم – كان الشريك الأساسي لحزب العدالة والتنمية في الحكومتين السابقتين، بل ولم يغادر الحكومة طيلة ثلاثة عقود على الأقل، بمعنى، إذا كان التصويت العقابي قد أسقط حزب العدالة الى أدنى مرتبة مما حصل عليه في أول مشاركة له سنة 1997، فكيف نجى شريكه من هذا العقاب؟
قبل التطرق لتوضيح هذه المفارقة، ينبغي التذكير بأن عقدي الثمانينات والتسعينات، قد طبعهما صراع اجتماعي كبير لعبت المركزيات النقابية وخاصة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل دورا محوريا فيه، فهذه الأخيرة هي التي قادت سلسلة من الاضرابات القطاعية والاحتجاجات الجماهرية أبرزها انتفاضة الدار البيضاء ل20 يونيو 1981 وانتفاضة فاس في 14 دجنبر 1990. وبين هاتين الانتفاضتين المترتبتين عن اضرابين عامين، هناك انتفاضات عدة في مدن مغربية اندلعت في شهر يناير 1984 بعد فرض سياسية التقويم الهيكلي والزيادات الكبرى في أسعار المواد الغذائية.
نهاية الثمانينات تميزت أيضا بدينامية النضال الحقوقي بتزامن مع انهيار جدار برلين، وتداعيات حرب الخليج الأولى وانهيار الاتحاد السوفياتي. في ذلك المنعطف الاستثنائي الذي عرف توقيع اتفاق أوسلو وتداعياته على المستويين الفلسطيني والعربي، اكتشف الملك الحسن الثاني إصابته بمرض السرطان، مما دفعه للشروع في ترتيب انتقال الملك لولي عهده، وهكذا بادر إلى الانفتاح على المعارضة اليسارية، وعقد صفقة مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي آنذاك، الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي تمثلت في إجراء تعديل للدستور، وانتخابات سابقة لأوانها وتشكيل حكومة ما سمي ب ” التناوب التوافقي “، وهي صيغة تعكس توازن القوى (أو توازن الضعف) بين القصر والكتلة الديمقراطية التي كانت مكونة من أربعة أحزاب وطنية معارضة. وبذلك انتهت أربعة عقود من الصراع على السيادة الشعبية والشرعية الديمقراطية، بإذعان أكبر أحزاب المعارضة للملكية التنفيذية.
ورغم معارضة أحزاب اليسار الديمقراطي، حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، وحزب النهج الديمقراطي، ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي لصفقة الكتلة الديمقراطية مع القصر، فإن إصرار قيادة الاتحاد الاشتراكي على مواصلة العمل حتى بعد انقلاب القصر عليها سنة 2002 بتعيين رئيس حكومة مستقل مكان الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي سيؤدي إلى انشقاق عمودي داخل هذا الحزب، فقد على إثره شبيبته والمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي كانت مرتبطة به. قوى اليسار الديمقراطي ستتكتل بعد ذلك في إطار “تجمع اليسار الديموقراطي” سنة 2004، الذي تحول بعد رفض النهج الديموقراطي المشاركة في الانتخابات سنة 2006 إلى تحالف اليسار الديمقراطي، الذي تطور بدوره الى “فيدرالية اليسار الديمقراطي “سنة 2014.
بالرغم من نجاح حكومة التناوب التوافقي في إخراج المغرب من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة، فإن عجزها عن الاستجابة للانتظارات الاجتماعية الكبرى للأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية، قد أدى إلى خيبة أمل لدى شرائح واسعة في المجتمع، وترتب عن ذلك نتائج خطيرة وبعيدة المدى وهي :
* تطبيع الأحزاب الوطنية مع الأحزاب الإدارية (التي أسستها الدولة العميقة) أكسب هذه الاخيرة شرعية كانت تفتقدها رغم مسؤوليتها عن إفساد الحياة السياسية وتمييعها.
* دخول الإسلام السياسي كفاعل سياسي قوي ومؤثر في المشهد السياسي سرعان ما تحول الى القوة الأولى في سياق ما سمي بالربيع العربي.
* التراجع المستمر لليسار بكل مكوناته، وتشتته بسبب الخلافات حول تقييم المرحلة، وكيفية التعامل معها، بالمشاركة في الحكومة أو معارضتها، بالمشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.
3 – الانتخابات كألية لإعادة هيكلة وضبط المشهد السياسي
تضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال التي قدمتها الحركة الوطنية المغربية في بداية 1944 إلى السلطات الاستعمارية مطلبين أساسيين:
الاستقلال الوطني والديمقراطية. وإذا كان المطلب الأول قد تحقق بعد إحدى عشر سنة من الكفاح الوطني المتعدد الاشكال، إذ انطلق بالإضرابات والمظاهرات وانتهى بالمقاومة المسلحة في المدن وعمليات جيش التحرير في البوادي، فإن مطلب الديمقراطية الذي أعتبر ثانويا في سياق الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، وحروب التحرير الوطني في البلدان المستعمرة، قد ظل معلقا الى أن انتهى الصراع على السلطة بين القصر والحركة التقدمية في بداية الستينات من القرن الماضي، بتمكن القصر من تقسيم الحركة الوطنية، وحل تنظيمات المقاومة وجيش التحرير بدعوى انتهاء مهامها، واستبدالهما بالجيش الملكي، معظم ضباطه كانوا في صفوف الجيش الفرنسي قبل الاستقلال.
هكذا، وبعد أربع سنوات فقط على الاستقلال، اختل ميزان القوى بشكل كامل لصالح القوى الرجعية المرتبطة بالاستعمار الجديد، وانطلقت معركة شرسة بينها وبين القوى التقدمية، وشكل المجلس التأسيسي والدستور والانتخابات العناوين الكبرى للصراع. وقد قاد الشهيد المهدي بن بركة ذلك الصراع بذكاء استراتيجي ومهارة تكتيكية، وتمكن من عزل النظام في الداخل والخارج، بفضل حسن توظيفه للانتخابات والبرلمان كواجهة نضالية، فاضطر النظام لحل البرلمان وإعلان حالة الاستثناء واغتيال الشهيد المهدي بن بركة بمساعدة المخابرات الصهيونية والأمريكية.
بعد عشر سنوات، كما أشرنا سابقا، سيحوّل النظام الانتخابات من آلية ديمقراطية للصراع الطبقي، وفرز القوى والبرامج التي تحظى بتأييد أغلبية الشعب، وضمان التداول السلمي على السلطة كما في الديمقراطيات التمثيلية العريقة، إلى آلية للتحكم في المشهد السياسي، وإعادة هيكلته بما يخدم مصالحه. لهذا الغرض تكلفت وزارة الداخلية باستقطاب النخب الاقتصادية والإدارية، وتأطيرها في أحزاب مختلفة الأسماء ومجندة لخدمة نفس المشروع، مشروع السلطة. في هذا السياق ،سيتم احتواء وتوحيد مجموعات الشبيبة الإسلامية تحت يافطة حزب إداري هو الحركة الشعبية الدستورية الذي أصبح حزب العدالة والتنمية في نهاية تسعينات القرن الماضي.
وظيفة هذا الحزب، كانت منذ البداية محددة في مواجهة اليسار، وخاصة داخل الجامعات، بدليل تورط بعض عناصره في اغتيال طالبين يساريين وممارسة إرهاب أسود، باستعمال العنف ضد خصومهم على مرأى ومسمع قوات الأمن في عدة جامعات. طبعا بعد أحداث 11 شتنبر 2001، ووقوع عمليات إرهابية بالدار البيضاء سنة 2003، والغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق، ستعم الموجة الأصولية المغرب أيضا، وتتوسع قاعدة العدالة والتنمية بشكل غير مسبوق، فانقلب السحر على ساحر النظام، وخاصة في سياق الربيع العربي والتوجيه الأمريكي آنذاك بالسماح لقوى الإسلام السياسي بالوصول للسلطة في بعض البلدان العربية ومنها المغرب. وتمكن حزب العدالة والتنمية بقيادة زعيمه الشعبوي من عقد صفقة مع النظام لتعطيل مطلب الملكية البرلمانية الذي رفعه حراك 20 فبراير، وسمح له باكتساح انتخابات 2012، ثم انتخابات 2015 و2016، ولولا نمط الاقتراع النسبي لحصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان لولايتين متتابعتين.
الآن تغيرت المعطيات الدولية والاقليمية بشكل جدري، وانتهت صلاحية هذا الحزب في نظر مهندسي الخريطة السياسية، وبالتالي أنزل إلى أدنى مرتبة، إذ لولا اللوائح الجهوية النسائية لحصل على أربعة مقاعد فقط، بعد أن كانت له 125 مقعد في مجلس النواب السابق.
بعد هذا العرض التوضيحي لخصوصية الانتخابات المغربية لابد من التأكيد على أهم الثوابت في تنظيمها، وهو أن تقدم أو تراجع حصة كل حزب مرتبط بمدى اقترابه أو ابتعاده (موالاته أو معارضته) لاختيارات الدولة العميقة (المخزن). هنا يبرز سؤال مشروع، وهو لماذا المشاركة في انتخابات متحكم في نتائجها سلفا بأكثر من 70 أو 80%؟ الجواب بسيط، وهو لأنها تشكل أكبر فرصة متاحة كل خمس سنوات لخوض توعية وتواصل مباشر ويومي مع الجماهير غير الخاضعة لأي تأطير سياسي أو نقابي أو جمعوي، وتعميق الوعي الديمقراطي، والتواجد بالمجالس المحلية المنتخبة لفضح لوبيات الفساد، وتقديم خدمات للمواطنين وللمواطنات متى كان ذلك ممكنا، وتوسيع وتجديد قواعد الأحزاب الديمقراطية في أفق تعديل ميزان القوى لتحقيق تغيير ديمقراطي حقيقي، أما المقاطعة فتزيد في تعميق اليأس والاحباط وتوسيع ظاهرة العزوف بإبعاد الشباب المتعلم والمتعاطف مع قوى اليسار عن النضال السياسي، وترك الساحة الانتخابية فارغة للأحزاب اليمينية لتعيث فيها فسادا .
* بقلم علي بوطوالة
الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والناطق الرسمي للجبهة العربية التقدمية.

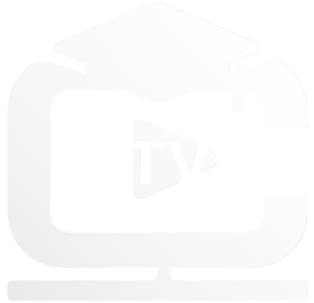


![[ID: SplxcD3ApP4] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/08/id-splxcd3app4-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: oycZWQBv-so] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/08/id-oyczwqbv-so-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: ZMiWOmdBoC8] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/08/id-zmiwomdboc8-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: XdwA2AFdX4c] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/08/id-xdwa2afdx4c-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: 8tFeJAGDu2Y] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-8tfejagdu2y-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: LNEIgo0dP7s] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-lneigo0dp7s-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: oCDJSQvT7UI] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-ocdjsqvt7ui-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: 66v7AQiN5G8] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-66v7aqin5g8-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: yRfOZxRpJZs] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-yrfozxrpjzs-youtube-automatic-1-360x203.jpg)
![[ID: g6oUbZI_IEI] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-g6oubziiei-youtube-automatic-1-360x203.jpg)
![[ID: 1luuXmXQ4KI] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-1luuxmxq4ki-youtube-automatic-1-360x203.jpg)
![[ID: shKLCi75YWw] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-shklci75yww-youtube-automatic-1-360x203.jpg)




![خاص: [ID: AUPOVTP40ys] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-aupovtp40ys-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: qaqoeuN_dsE] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/07/id-qaqoeundse-youtube-automatic-360x203.jpg)
![خاص: [ID: w7FjF_h-4Xc] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/07/id-w7fjfh-4xc-youtube-automatic-360x203.jpg)
![خاص: [ID: wp2KO3gEIc0] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/07/id-wp2ko3geic0-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: uyt0SXo1m-0] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/02/id-uyt0sxo1m-0-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: Ss02PBJUjGo] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/02/id-ss02pbjujgo-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: GVB4OL7Fo3I] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/02/id-gvb4ol7fo3i-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: vcwhmCGsYMY] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/02/id-vcwhmcgsymy-youtube-automati-360x203.jpg)
![[ID: QQGE9bmQ5fY] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/02/id-qqge9bmq5fy-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: mqP6TotIRLo] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/02/id-mqp6totirlo-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: eoft3aRkhYE] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/02/id-eoft3arkhye-youtube-automatic-360x203.jpg)

![[ID: jkXBixeZjZE] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/02/id-jkxbixezjze-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: o8Pa6uK5bbw] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/02/id-o8pa6uk5bbw-youtube-automatic-360x203.jpg)


![خاص: [ID: IGB9cmFIjq0] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/02/id-igb9cmfijq0-youtube-automati-360x203.jpg)
![[ID: 3jcBsN8wVGo] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-3jcbsn8wvgo-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: M8IM9s5Ddiw] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-m8im9s5ddiw-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: qbol2X6ahug] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-qbol2x6ahug-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: TL2nAJwpIRs] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/04/id-tl2najwpirs-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: eK5_eDDwvLc] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/04/id-ek5eddwvlc-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: IMfmbP5VkJs] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/04/id-imfmbp5vkjs-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: c1lM8tb4_NU] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/03/id-c1lm8tb4nu-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: CQh8QDII3LA] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-cqh8qdii3la-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: CHB4wqkQoD8] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-chb4wqkqod8-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: x3uQAE4xcW4] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-x3uqae4xcw4-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: XeMnPURyPeY] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-xemnpurypey-youtube-automatic-360x203.jpg)
![خاص: [ID: coUuGUYPcS4] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/05/id-couuguypcs4-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: 5XHTMVS7C7Q] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2021/05/id-5xhtmvs7c7q-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: bJWTnGoF4vA] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2021/05/id-bjwtngof4va-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: o40VpK6Emdc] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2021/03/id-o40vpk6emdc-youtube-automati-360x203.jpg)
![[ID: 7bNS4oWtOSk] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2020/10/id-7bns4owtosk-youtube-automatic-360x203.jpg)


![[ID: l2IeQ7HvrUU] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2020/10/id-l2ieq7hvruu-youtube-automatic-360x203.jpg)

