
أزمة الجامعة المغربية العمومية على ضوء ما شاع من فضائح الأخلاقية
عبثا تحاول الجامعات المغربية أن ترقى إلى مصاف الجامعات المصنفة عالميا وفق المؤشرات المعتمدة في تصنيف الجامعات على الصعيد الدولي. ولا يعود السبب في ذلك إلى نقص في خبرة الأساتذة الجامعيين أو ضعف في تكوينهم العلمي. فالجامعيون المغاربة يحصدون أكبر الجوائز العلمية وينشرون في أشهر المجلات العلمية المعروفة بصرامة مقاييسها وتحكيمها. كما لا يرجع السبب إلى عجز الطالب المغربي عن استيعاب مناهج العلوم الإنسانية والتقنيات الحديثة. فالطلبة المغاربة يحتلون المراتب الأولى عندما يلتحقون بجامعات أجنبية لاستكمال دراستهم العليا. إن الخلل يكمن في الظروف القاسية التي تحكم التعليم العالي ببلادنا، خاصة عنما يتعلق الأمر بالمؤسسات الجامعية التي لا تضع أي شرط من أجل التسجيل بها، والتي تسمى مؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
إن من يتأمل أوضاع الجامعة العمومية اليوم، يصل دون شك إلى أن مشاكلها أصبحت تستعصي على الحل، وأضحت “بفعل فاعل” تتعرض للتآكل والهدم، وهذا ما يهدد هذه الصروح العلمية التي نسميها جامعات، في كيانها وهويتها، ويحول دون قيامها بالدور الذي ظلت تقوم به منذ الاستقلال إلى الآن.
فقد أدت الحالة المأساوية التي آلت إليها أوضاع الجامعة العمومية إلى بروز بعض الظواهر التي كانت تعد قبل عقدين من الزمن غريبة عن الحرم الجامعي، ومنها تفشي العنف الذي طال الأساتذة والطلبة معا. ومنها هذه الممارسات غير أخلاقية التي تتمثل في الابتزاز الجنسي، والتي تمس مكانة الجامعة الاعتبارية، اجتماعيا وعلميا وثقافيا بوصفها فضاء للمعرفة والتربية على إنتاج القيم النبيلة واحترام التعدد والإيمان بالاختلاف وفضيلة الحوار.
لنسلم أولا بأن آفة التحرش الجنسي ممارسة متفشية في المجتمع بشكل يكاد يجعل منها ظاهرة من الظواهر، على الرغم من القوانين الزجرية التي سنت في السنوات الأخيرة من أجل الحد من هذا السلوك المدان، الذي يتعارض مع قيمنا الاجتماعية والدينية. ومع ذلك فإن ما يجعل من تسجيل بعض حالات التحرش بالجامعة حدثا هو أنه يمارس بين أسوار الحرم الجامعي، ومن طرف أشخاص من المفروض أن المجتمع أوكل إليهم محاربة مثل هذا السلوك المشين.
من هنا فإن ما حدث في سطات ووجدة خلال الأيام الأخيرة، والذي لا يستبعد أنه حدث في جامعات أخرى، يستحق وقفة تأمل للإجابة على السؤال: لماذا وصلت الأوضاع في الجامعة المغربية إلى هذا المستوى من الانحدار؟
لا شك في أن هذا السؤال سؤال متشعب يتطلب بحثا مفصلا في مكونات الجامعة، وعلاقة هذه المكونات بعضها ببعض، باعتبارها مجتمعا مصغرا، وبالتالي فإن ما يحدث في المجتمع ليس بعيدا عن الجامعة.
بعض الأقلام التي انبرت لـ “تغطية” حالات التحرش الجنسي ببعض الجامعات المغربية رأت في هذا السلوك حدثا مثيرا يجلب القارئ وكفى. وبعضها جعل منه مناسبة لتسفيه الجامعة العمومية والحط من دورها الحاسم في قيادة التنمية بكل أنواعها.
لذلك لجأت بعض تلك الأقلام إلى تضخيم هذه الحالات بطريقة توحي بأنها ظاهرة عامة تغطي كل المؤسسات الجامعية على طول البلاد وعرضها. في حين أن الأمر لا يتعدى مؤسستين جامعيتين من بين عشرات المؤسسات. كما أن “المشتبه” في ارتكابهم لهذا الفعل الشنيع لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة من بين أكثر من خمسة عشر ألف أستاذا جامعيا. أليس من الممكن أن نعثر على خمسة مرضى من بين خمسة عشر الف، خاصة في ظل غياب التأطير القبلي الذي يؤهل الباحث كي يصبح أستاذا جامعيا؟
وعلى الرغم من أن المشكل يستحق الوقوف عنده، بما يفضي إلى التفكير في ميثاق وطني يحدد أخلاقيات المهنة من أجل محاربة مثل هذا السلوك الذي يتطلب كل أشكال الإدانة، والضرب على يد كل من تسول له نفسه استغلال موقعه لابتزاز الطالبات والطلاب، إلا أن ذلك لا يمنع من تسجيل أن ما حدث استغل استغلالا بشعا للإساءة إلى الجامعة المغربية العمومية، ولخدش سمعة عشرات المئات من الأساتذة الجامعيين الذين يقدسون مهنتهم ويمارسونها بكثير من الإخلاص والتفاني.
إن التعامل مع الواقعتين اللتين حدثتا في سطات ووجدة من طرف بعض الصحافة الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، يمنح الانطباع باستغلال ما وقع لتصفية الحساب مع الجامعة العمومية وصرف الأنظار عن المشاكل البنيوية التي تتخبط فيها، لصالح مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي أصبحت تنبت كالفطر في المدن الكبرى.
وعوض العمل على ترسيخ مبدأ الشراكة بين الجامعة العمومية والقطاع الخاص، الذي بشر به الميثاق الوطني للتربية والتكوين منذ سنوات، وكرسته محاولات الإصلاح الجامعي المتتالية للخروج من هذه الوضعية، اختار المسؤولون عن التعليم العالي الهروب إلى الأمام، فدعوا إلى فتح الباب أمام الرأسمال الوطني و الأجنبي كي يستثمر في عقول المغاربة. ومن ثم انحازوا إلى اختيار يزيد التعليم العالي تشتتا ويعرضه للبيع والشراء في سوق البورصة الذي تكون الغلبة فيه لمن يدفع أكثر.
هذا يعني أن توحيد التعليم العالي ومجانيته، وهما من المبادئ التي دافع عنها المغاربة منذ الاستقلال، أصبحا من الماضي، مما خلق جوا من انعدام الثقة في الجامعة العمومية وأدى إلى خلل في تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
لا ريب في أن هذا “الاختيار” الذي يوضح إلى حد تعبت الدولة بأبنائها، يعمق الشرخ بين “تعليم نخبوي” تتوفر له كل شروط النجاح، و”تعليم عمومي” توضع في وجهه كل العراقيل التي تحول دون أن يؤدي مهمته على الوجه الأكمل.
هناك من يرى في هذا الموقف السلبي من “الجامعات خاصة” نشازا، متذرعا بأن السياق الحالي لم يعد يتحمل هذه الغيرة الزائدة على الجامعة العمومية، في ظل سيادة منطق السوق وهيمنة الرأسمالية، المتوحشة منها والناعمة. ولكن موقف الدفاع عن الجامعة العمومية ينهض على منطق بسيط، مفاده أن علينا أولا أن نؤهل جامعاتنا، بشكل يجعلها مستعدة لخوض غمار المنافسة الذي يؤدي إليه فتح جامعات خاصة، ويمنحها القدرة على الصمود في وجه الرأسمال العالمي. ولكي تتأهل الجامعة المغربية لتقوم بهذا الدور، عليها أن توفر للأستاذ والطالب معا نفس الشروط التي توفرها الجامعات الخاصة.
وواقع الجامعة العمومية اليوم يشير إلى أنها تعرف انتكاسة حقيقية على جميع المستويات، وجهها البارز أن أكثر من أربعين في المائة من الطلبة يغادرون الجامعة دون الحصول على أية شهادة، وأن أغلب الذين يصمدون حتى يحصلوا على الشهادات لا يجدون شغلا يتماشى مع بتكوينهم. والسبب في ذلك راجع إلى أن المحاولات المتكررة لإصلاح التعليم العالي ببلادنا، لم تنبع من إرادة سياسية حقيقة تضع الجامعة في المكانة التي تستحقها باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن ثم ظلت الحكومات المتتالية تنظر إليها على أنها عبء مالي على الدولة. في حين أن كل إصلاح للتعليم العالي له كلفته المادية لأنه استثمار حقيقي من أجل المستقبل.
لا يمكن للجامعة العمومية أن تحتل مكانتها بين جامعات العالم إلا إذا وجدت حلولا لبعض المعضلات التي رافقتها منذ سنين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر معضلة الاكتظاظ. فالأستاذ بالجامعة المغربية ما زال يلقي دروسا أمام أكثر من خمسمائة من الطلبة دفعة واحدة، وما زال يصحح أكثر من ألفي نسخة من أوراق الامتحانات، وما زال يجري الأعمال التطبيقية والتوجيهية لعدد يستحيل معه التواصل المباشر مع جميع الطلبة كل على حدة.
كما لا يمكن للجامعة المغربية أن تحتل مكانتها بين جامعات العالم إلا إذا وفرت للأستاذ شروط البحث العلمي. والحال أن أساتذة التعليم العالي بالمغرب ينفقون من أجورهم الخاصة كي ينجزوا أبحاثا، ونحن في المغرب من الدول القليلة في العالم التي تصر على فرض ضريبة على البحث العلمي، كي تزيد على كاهل الأستاذ ثقلا على ثقل.
وأخيرا فإن الجامعة المغربية بحاجة إلى تدبير جيد لشؤونها، وإلى دمقرطة حقيقية لتسييرها وإلى استقلالية كاملة تجعلها بمنأى عن تقلبات أمزجة الحكومات والوزراء. ذلك أن الفساد الذي طال مرافق كثيرة في الحياة العامة ببلادنا بدأ يتسرب شيئا فشيئا إلى الجامعة المغربية، ولعل التحرش الجنسي أحد وجوهه فقط…
بقلم الأستاذ حسن مخافي

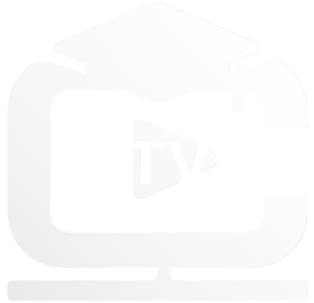


![[ID: SplxcD3ApP4] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/08/id-splxcd3app4-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: oycZWQBv-so] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/08/id-oyczwqbv-so-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: ZMiWOmdBoC8] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/08/id-zmiwomdboc8-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: XdwA2AFdX4c] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/08/id-xdwa2afdx4c-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: 8tFeJAGDu2Y] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-8tfejagdu2y-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: LNEIgo0dP7s] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-lneigo0dp7s-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: oCDJSQvT7UI] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-ocdjsqvt7ui-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: 66v7AQiN5G8] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-66v7aqin5g8-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: yRfOZxRpJZs] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-yrfozxrpjzs-youtube-automatic-1-360x203.jpg)
![[ID: g6oUbZI_IEI] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-g6oubziiei-youtube-automatic-1-360x203.jpg)
![[ID: 1luuXmXQ4KI] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-1luuxmxq4ki-youtube-automatic-1-360x203.jpg)
![[ID: shKLCi75YWw] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-shklci75yww-youtube-automatic-1-360x203.jpg)




![خاص: [ID: AUPOVTP40ys] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-aupovtp40ys-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: qaqoeuN_dsE] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/07/id-qaqoeundse-youtube-automatic-360x203.jpg)
![خاص: [ID: w7FjF_h-4Xc] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/07/id-w7fjfh-4xc-youtube-automatic-360x203.jpg)
![خاص: [ID: wp2KO3gEIc0] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/07/id-wp2ko3geic0-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: uyt0SXo1m-0] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/02/id-uyt0sxo1m-0-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: Ss02PBJUjGo] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/02/id-ss02pbjujgo-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: GVB4OL7Fo3I] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/02/id-gvb4ol7fo3i-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: vcwhmCGsYMY] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/02/id-vcwhmcgsymy-youtube-automati-360x203.jpg)
![[ID: QQGE9bmQ5fY] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/02/id-qqge9bmq5fy-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: mqP6TotIRLo] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/02/id-mqp6totirlo-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: eoft3aRkhYE] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/02/id-eoft3arkhye-youtube-automatic-360x203.jpg)

![[ID: jkXBixeZjZE] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/02/id-jkxbixezjze-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: o8Pa6uK5bbw] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/02/id-o8pa6uk5bbw-youtube-automatic-360x203.jpg)


![خاص: [ID: IGB9cmFIjq0] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/02/id-igb9cmfijq0-youtube-automati-360x203.jpg)
![[ID: 3jcBsN8wVGo] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-3jcbsn8wvgo-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: M8IM9s5Ddiw] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-m8im9s5ddiw-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: qbol2X6ahug] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2026/01/id-qbol2x6ahug-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: TL2nAJwpIRs] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/04/id-tl2najwpirs-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: eK5_eDDwvLc] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/04/id-ek5eddwvlc-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: IMfmbP5VkJs] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/04/id-imfmbp5vkjs-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: c1lM8tb4_NU] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2024/03/id-c1lm8tb4nu-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: CQh8QDII3LA] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-cqh8qdii3la-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: CHB4wqkQoD8] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-chb4wqkqod8-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: x3uQAE4xcW4] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-x3uqae4xcw4-youtube-automatic-360x203.jpg)
![[ID: XeMnPURyPeY] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/08/id-xemnpurypey-youtube-automatic-360x203.jpg)
![خاص: [ID: coUuGUYPcS4] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2025/05/id-couuguypcs4-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: 5XHTMVS7C7Q] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2021/05/id-5xhtmvs7c7q-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: bJWTnGoF4vA] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2021/05/id-bjwtngof4va-youtube-automati-360x203.jpg)
![خاص: [ID: o40VpK6Emdc] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2021/03/id-o40vpk6emdc-youtube-automati-360x203.jpg)

![[ID: 7bNS4oWtOSk] Youtube Automatic](https://campustv.ma/wp-content/uploads/2020/10/id-7bns4owtosk-youtube-automatic-360x203.jpg)



